نفس المؤمن ” المحافظ ” تميل إلى الرأي الأول أي التجديد بالعودة إلى الماضي والأمر الأول ، وتستنكر المذهب الثاني أي التجديد بالتطوير والتحديث . وكلاهما – من وجهة نظري – صحيح لا تعارض بينهما لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من البيان ليشرح الله صدر المتردد في قبول ذلك .
إذا نظرنا في الإرث النبوي فإنّنا نجد بلا نزاع أنّ أعظم ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من أمر الدين هو القرآن الكريم .
أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله النبي الأميّ وهو مقيم في أمّة أميّة لا تعرف الحساب ولا الكتاب ، فلم ينزل القرآن الكريم دفعة واحدة في كتاب مرقوم كما أُنزل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام ، بل نزل منجماً مفرّقاً ، منه ما نزل في العهد المكي ، ومنه ما نزل في العهد المدني ، ومنه ما نزل في الحضر ومنه ما نزل في السفر والمغازي ، ووعد الله نبيّه أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء ، ولا يَخلَق من كثرة الردّ ، فجعل الأميّة وتخلف العرب آيةً من آيات صدق النبوة فأنزل قوله سبحانه :
“وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ، بل هو آيات بيات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ” [ العنكبوت 48/49 ]
فلقّن النبي صلى الله عليه وسلم من حضر من أصحابه كلامَ الله حرفاً حرفاً فحفظوه في الصدور ، فتفرّق القرآن في صدور أصحابه كلٌّ قد حفظ ما تيسر منه ، فلما هاجر إلى المدينة المنورة وخرج من مرحلة الاستضعاف فتمكن في الأرض تعلّم بعض أصحابه القراءة والكتابة فاتخذ منهم كتّاباً للوحي ، وكانت للعرب ألسن [ لهجات ] فأنزل الله تعالى القرآن على سبعة أحرف تيسيراً للذكر والضبط لكونها أمّة تغلب عليها الأُمّيّة ، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك القرآن الكريم مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال .
وما إنْ مات المصطفى صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق حتى دخلت الأمة الإسلامية في صراع عتيد مع حركات الردّة والأمم المناهضة للإسلام ، وخرجت جيوش المسلمين للفتوحات فتفرّق الأصحاب في الأمصار وتشتت معهم القرآن ، فأصبح القرآن الكريم عرضة للضياع ، وكان الأمر أشبه بالفوضى العارمة مع غياب المرجع الأعلى لضبط القرآن الكريم أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتيج إلى تطوير وتحديث نُظم حفظ القرآن رغم النفور من الحداثة.
ويعكس ذلك المشهد الدراماتيكي ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان من كتّاب الوحي قال :
أرسل إليّ أبو بكر مَقتَلَ أهل اليمامة وعنده عمر ، فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحَرَّ يومَ اليمامة بالناس ، وإني أخشى أن يستحرَّ القتل بالقرّاء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه ، وإني لأرى أن تجمع القرآن ، فقال أبو بكر ، قلت لعمر :
كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ؟
فقال عمر : هو والله خير ، فلم يزل عمر يُراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ، ورأيت الذي رأى عمر ، قال زيد بن ثابت : وعمر عنده جالس لا يتكلم ، فقال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل ، ولا نتّهمك ، وكنتَ تكتبُ الوحيَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبّع القرآن فاجمعه ، والله لو كلّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن الكريم ، قلتُ :
كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ؟
فقال أبو بكر : هو والله خير ، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر أبي بكر وعمر ، فقمتُ فتتبعتُ القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال – إلى قوله – : وكانت الصُحُف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفّاه الله ثم عند عمر حتى توفّاه الله ، ثم عند حفصة بنت عمر ” انتهى الحديث .
كانت تلك هي المرحلة الأولى من التطوير ، بجمع القرآن الكريم كاملاً ، مكتوباً في صُحُف ثم حِفظها تحت سقف واحد وكان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تردّد الصديق رضي الله عنه في قبوله حتى شرح الله صدره.
وللحديث بقية .
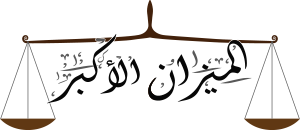 Almizan Al Akbar
Almizan Al Akbar



