يولد الإنسان السليم على الفطرة كالصفحة البيضاء لا يعلم شيئاً ولا يعقل شيئاً، يسمع الأصوات من حوله، ويبصرُ الصُوَر، ويشم الروائح، ويلمس الموجودات، ويتذوّق الطعام، فإذا جاع عجز عن التعبير عمّا في ضميره إلا بالبكاء والحنو على أمّه حتى يشرع في النطق حرفاً حرفاً، وكلمة كلمة، فيرتقي إلى مرحلة المحاورة والأخذ والعطاء والرغبة في المعرفة والتجربة فينشط المخّ بالحفظ والتخزين والتحليل والنقد والابداع والابتكار، هذا هو الإنسان الذي كرّمه الله بأحسن تقويم.
فإذا تدرّب الإنسان منذ صباه على أدب السؤال لطلب العلم النافع ووجد من حوله من يُنصت إليه ويجيب فُتحت له أبواب المعارف، فالسؤال هو مفتاح العلوم كما قال الله سبحانه وتعالى:
“فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”
وكما جاء في الأثر:
“ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاءُ العِيِّ السؤال”
فإذا ارتقي المخ من مرحلة “العقل البدائي البليد” إلى مرحلة “العقل الذكي” احتاج إلى مراجعة الجواب إذا لم يقنع به، فيراجع بالاعتراض أو الاستفهام أو يعيد السؤال من وجه آخر ليتحقق من المعلومة وهو الذي نسمّيه حديث “المحاورة”.
كل ما كان على وزن مفاعلة فهو فعل بين طرفين أو أكثر، والمحاورة أصناف وأنواع منها؛ المراجعة والمناظرة والمجادلة والمساجلة والمناقشة والمذاكرة والمحاججة والمخاصمة وغيرها، ولكل كلمة مما تقدّم صفة خاصة لنوع المحاورة.
المحاورة باللسان المبين هبة ربّانية لفتح آفاق المعارف وتطوير العلوم، ولئن كان السؤالُ مفتاحَ العلوم فإن المحاورة هي مفاتيحُ الضبط والدقّة، والفقه والفهم، والتأصيل والبناء، والتطوير والابداع، أو بعبارة أخرى:
“المحاورة مفتاح الذكاء”
إنّ المدارس التعليمية التي تعتمد منهج الصمت المطبق: “احفظ ما تسمع ولا تحفظ غيرَ ما تسمع، ولا تسأل عن شيء لم تسمعه” هي “مدارس الأنعام” تقود الأمّة إلى القهقرى والفناء والزوال.
والمدارس التي تفسحُ للسؤال وتمتنع المراجعة بإغلاق باب النظر والاجتهاد هي “مدارس الجمود والتقليد الأعمى”، حالها كحال الصفّ حين يقول ضابط الصفّ:
“مكانك سِر”
لا تقدّم ولا إبداع ولا تطوير.
أما المدارس يُنَشّأ فيها طالبُ العلم على منهج المحاورة والمراجعة بالنقض والنقد، والتدقيق والتصحيح والتدقيق فتلك مدارس الأجيال الذكيّة القادرة على البناء والاجتهاد والإبداع والتطوير.
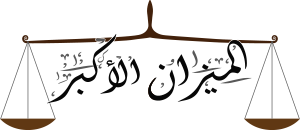 Almizan Al Akbar
Almizan Al Akbar



